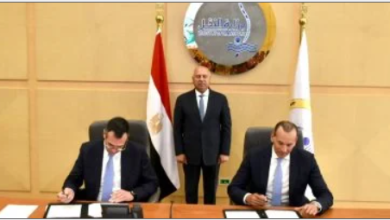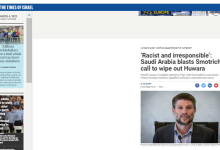سوف يظل التاريخ شاهدا على ما جرى خلال العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى فى قلبها. ما جرى سمى فى البداية الربيع العربى، وفيما بعد تراوحت الأسماء بين الشتاء والخريف، ولكن الجوهر بقى ثابتا وأنه قد جرى نوعان من التناقضات والمواجهات: أولهما بين جماهير غفيرة ونظم سياسية لم تكن قادرة على عبور زمنها المتيبس إلى مستقبل أكثر إشراقا، وثانيهما بين ذات الجماهير ومحاولة الإخوان المسلمين وتابعيهم من تنظيمات راديكالية شتى للاستئثار بالسلطة واستخدامها لإقامة نظم سياسية مشتقة بطريقة أو أخرى من النظام السياسى الإيرانى، أو الأفغانى عندما كانت أفغانستان تحت حكم طالبان. ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ المصرية كانت نقطة فارقة لأنها هزمت المشروع الإخوانى، ومن ساعتها والمشروع يواجه تقلصات كبيرة فى الدول العربية الأخرى.
ما أضافته التجربة المصرية هو أنه ليس كافيا الثورة على نظام قديم، أو الإطاحة بجماعة الإخوان، وإنما لابد وأن يصاحب ذلك مشروع وطنى للبناء والرفعة تدخل الدولة إلى العصر الذى يعيش فيه العالم. ولم تكن هناك صدفة أنه خلال نفس المرحلة بدأت تجارب كثيرة اتخذت مسار رؤى اختلفت عناوينها من رؤية «٢٠٣٠» إلى رؤية «٢٠٣٥» فى دول مصر والسعودية والكويت والبحرين والأردن والمغرب وعمان، وكلها تبغى الإصلاح العميق فى الداخل.
وفى يوم الأحد ١٦ يونيو ٢٠١٣ نشرت مقالا فى هذه الصحيفة الغراء بعنوان «تأملات يوم القيامة!»، وصفت فيه ما كان جاريا فى ذلك الوقت وآخذا مصر ومعها إقليمها إلى الثلاثين من يونيو فى لحظة فائرة وهادرة من التاريخ. وأنهيت المقال بما يلى: «الأمر كله يبدو وكأنه يحدث فى ظل سياق تاريخى تكون له دوراته وموجاته التى تذهب وتجىء، وكانت قناعتى الدائمة أن ما جرى منذ أكثر من عامين كان مجرد بداية لعملية أكبر من الخيال سوف تستمر معنا حتى نهاية العقد الحالى وربما ما بعده. ومن يظن أن يوم الثلاثين من يونيو سوف يضع خط النهاية هنا أو هناك فإنه لا يعلم الكثير عن أيام القيامة البشرية».
الآن وبعد مضى ثمانى سنوات يمكننا تقييم ما جرى بقدر من التفاؤل، حيث حدث ما يحدث فى أيام القيامة من زاوية الحساب والبحث فى الأسباب والشعور بالبعث والتجديد مثل طائر العنقاء الذى يخرج من الرماد قويا وعفيا، مضافا لها البحث عن مستقبل مختلف عما مضى. لم يتم ذلك بطريقة متوازية أو متساوية، فالملكيات والإمارات نجت من الأحداث العظمى، لكنها كانت شاهدة على فساد الجمود الذى يقود إلى إسراف سلفى الذى يمهد لانفجارات ليس لها حساب. ودخلت دول مثل سوريا واليمن فى حروب أهلية أو الوقوف على مشارفها مثل ليبيا، وفى دول أخرى مثل السودان ولبنان والعراق والجزائر تقلبت ما بين الحفاظ على ما هو قائم، والحراك الذى يحاول الخروج منه. وفى دول أخرى مثل تونس دخلت فى حالة من الجدل المحلى يعطى شكلا من الديمقراطية التى تبوح بتناقضات الدولة ما بين الإخوان والعلمانيين، وما بين المدنية والتطرف، وفى كل الأحوال تفصح عن عجز تنموى واضح.
وفى مجموع هذه الحالات تشكلت البيئة الإقليمية التى كان على مصر التعامل معها خلال ذات المرحلة، وكان الشائع فى التفكير السياسى المصرى يدور حول قياس الحركة بمعيار «دور مصر الإقليمى» الذى لا يفارق فى المخيلة أشكال «الدور» السابق قبل عقود، باعتباره عصرا ذهبيا الذى آن الأوان له أن يعود مرة أخرى، وكما وصف الوقت على صوت فيروز بأن مصر عادت شمسها الذهبى.
لا جدال فى أن هناك بعضا من الملامح لوقتنا هذا، ربما تثير أشجانا سابقة، ولكن التاريخ أولا لا يعيد نفسه وإنما ثانيا يعيد اختراع حاضره. مسميات الماضى لا توجد فيها الكفاءة للتعامل مع العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين والذى دخلته مصر استنادا أولا إلى الدفع الكبير فى بناء عناصر القوة المصرية الخشن فيها والناعم والذكى، وثانيا أن هذا الدفع دلف إلى العقد من خلال رؤية لايزال أمامها تسع سنوات حتى تكتمل وتبلغ التمام الذى يضع قاعدة لرؤية أخرى لن يكون العالم والإقليم فيهما ليس كما كان.
الحالة ولا شك مغرية بلحظة «مصرية» جديدة تقاس على سابقتها، ولكنها فى شكلها الحالى ليست رهانا على لحظة وتنطفئ، ولكن على زمن يزدهر ويدوم، ولا يكون كل ذلك إلا عندما يكون تمام التكافؤ بين عناصر القوة، والحركة الخارجية، وكفاءتها وفاعليتها. وإذا كانت عملية البناء جارية بقوة واندفاع فى الداخل، فإن الحركة فى الإقليم تجرى بصبر وحرص وحزم طبيب يجرى عمليات جراحية فى مخ إقليم استعصى على التقدم (وبالمناسبة التقدم غير الغنى!)، بقدر ما بات استثناء على التغيير.
تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى وطاقمه السياسى والدبلوماسى فى المجال الإقليمى قائمة بشدة على خدمة عمليات التحديث القائمة على قدم وساق فى الداخل وبعضها فى الخارج لدفع الضرر، والبعض الآخر لإضافة القدرات. راقب بشدة كم المناورات العسكرية التى تجريها مصر مع دول شقيقة وصديقة، ومعها مناسبات للحوار وتبادل وجهات النظر حول المصالح، والأهم السعى إلى تحقيق الاستقرار فى الإقليم. لا يمكن فى بلد مثل مصر أن تحقق الاستدامة فى داخلها وسط بيئة مضطربة وساخنة، وفى نفس الوقت فإنها فى سعيها إلى التأمين والتبريد، فإنها لا تريد الانجرار والاستدراج لا وراء شعارات تجاوزها الزمن، ولا وراء أهداف تراجعها القدرة.
وسواء كان العمل المصرى فى ليبيا أو السودان أو غزة أو العراق، والتعاون مع السعودية والإمارات، فإن التعامل يكون أولا بهدف الهزيمة الكاملة للمشروع الإخوانى والراديكالى المتطرف، وثانيا إعطاء الفرصة الكبيرة للتنمية الاقتصادية فى مصر والدول والأسواق القريبة. تعمير سيناء يمتد فى السياسة الخارجية إلى إقامة جسر سكانى يضع الحضور المصرى فى تلامس بشرى مع المشرق، وتنمية الساحل الشمالى يضع الأنامل المصرية فى تلامس مع غربها.
الحركة المصرية كان فيها الكثير من الإبداع، وتشكيل منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط، ليس فقط تجمعا لإنتاج الغاز، وإنما أيضا من الزاوية «الجيو سياسية» يفتح الباب للتعايش الفلسطينى الإسرائيلى يماثل ذلك الذى قام بين فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية فى إطار تجمع للحديد والصلب. الحركة فى اتجاه الأردن والعراق تمت بشجاعة ورشاقة وحرص، لأن «المسؤولية الإقليمية» لمصر تحتم السعى الحثيث والماهر من أجل إطفاء حرائق التهبت طوال عقد كامل، وباتت المسألة هى إطفاؤها أو على الأقل إبقاء شررها بعيدا.
الحركة دقيقة وحريصة، فالسودان بعد إسقاط حكم الإخوان يواجه تحديات هائلة، وليبيا هى الأخرى ذهبت إلى طريق لم يصل بعد إلى نقطة اللاعودة، وبعد حرب غزة الرابعة فإن الفصائل الفلسطينية والفصائل الإسرائيلية لاتزال واقفة وراء أشجار، متجاهلة الغابة العميقة وراءها، وما يفتحه الإعمار لها من أبواب. المسؤولية الإقليمية المصرية هى فى الأول والآخر تمد مشروع التحديث المصرى فى الفكر والبناء والسلام والتعاون إلى منطقة الجوار القريب. وللأمر تفاصيل كثيرة!.