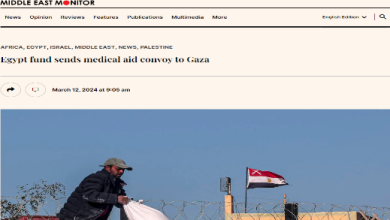سعد الدين ابراهيم يكتب : خلية نحل محمد عُثمان الخُشت تحت القُبة الجامعية
يُضرب المثل عادة بعُزلة وهدوء الحرم الجامعى والمكتبات، من هرج ومرج الحياة المُعاصرة فى الشوارع والميادين.
وربما كانت كتابة لفظ الحرم الجامعى، مثلما الحرم المُقدس فى كل من مكة والمدينة وبيت المقدس، هى التى أوحت للجيل الذى أسّس الجامعة المصرية، التى أعيد تسميتها بجامعة فؤاد الأول، وأخيراً إلى جامعة القاهرة، باختيار مصطلح الحرم الجامعى، كتسمية للجامعة وأرضها، توقيراً لمَن يرتادها من الأساتذة والطلبة، واحتراماً للحُرية التى ينبغى أن يتمتعوا بها، فى بحوثهم ودراساتهم، دون حسيب أو رقيب عليهم إلا من ضمائرهم.
وضمن هذه القداسة لحُرية البحث والرأى، تُرك للجامعة نفسها حق وحُرية مَن يُحافظون على الأمن فيها، من إدارة الجامعة نفسها. فكان ثمة حرس جامعى لا يحمل سلاحاً، ولكن له زى خاص يُميزه ويُعطيه الحق فى حفظ النظام، وفض أى اشتباكات قد تحدث بين الجامعيين أنفسهم.
وبتلك الاستقلالية التى احترمتها معظم الحكومات والأنظمة التى حكمت مصر فى المائة سنة الأخيرة، كانت هناك انتقادات بأن الجامعة والجامعيين خلف أسوارها، يعيشون فى أبراج عاجية، ولا يتفاعلون مع المجتمع المصرى الأكبر، أو يشعرون بمشكلاته وأوجاعه.
واستجابة لذلك النقد الموضوعى المشروع، انبرى بعض رؤساء الجامعة للاشتباك مع المشكلات الكُبرى التى تواجه المجتمع المصرى، ودعوة مَن يستطيعون إلقاء الضوء على مظاهرها، وأسبابها، وطُرق علاجها. وفى هذا الصدد جال وصال آخر رئيسين لجامعة القاهرة، وهما د. محمد جابر نصار، ود. محمد عُثمان الخُشت.
كان جابر نصار قانونياً فذاً أتى إلى الموقع من كُلية الحقوق، ووظّف الأدوات القانونية لمُحاصرة التطرف الدينى المتأسلم، الذى ارتدى الإخوان المسلمون عباءته، واستطاع بالفعل أن يُحاصر نشاطهم، ويحمى الجامعة من تغولهم، وابتزازهم لزُملائهم وأساتذتهم.
وحين خلفه د. عُثمان الخُشت، أشفقت على الرجل الذى كان قد قدمه لى أستاذه د. حسن حنفى، الذى قال لى إنه من أفضل تلاميذه. وبناءً على تِلك التوصية من فيلسوف كبير مثل حسن حنفى، تعاونت مع عُثمان الخُشت لسنتين فى مركز ابن خلدون، قبل قضيتى الشهيرة حول مراقبة الانتخابات، والادعاء بتزويرها فى أواخر عام 1999.
وتفرقت بنا السُبل، ولكن كان انطباعى الأساسى عن عُثمان الخُشت، هو أدبه الجم، وأسلوبه الشديد التهذيب مع كل مَن يتعامل معهم.
كما انخرط عثمان الخُشت فى أنشطة عامة، وخاصة تِلك التى لها علاقة بتطور المنظومة التعليمية.
وكان لسان حال عُثمان الخُشت هو: إذا كانت أقوى دول العالم تطلق صيحة الخطر بسبب نواقص منظومتها التعليمية، فإننا فى مصر والعالم الثالث الأكثر احتياجاً لشن حرب ممتدة على نظامنا التعليمى البائس، الذى أصابه الجمود منذ أطلق طه حسين مقولته الراسخة عن أن التعليم مثل الماء والهواء لبقاء وصلاح البشر.
ولذلك حينما اعتلى عُثمان الخُشت نفس الكرسى الذى شغله طه حسين كعميد للآداب، ثم بعد ذلك رئاسة جامعة القاهرة، تحول إشفاقى على الرجل إلى متابعة نشطة لما عساه أن يفعل فى ذلك الموقع الخطير. فإذا بالفيلسوف يُحول الجامعة إلى منظومة مترابطة داخلياً من ناحية، ثم ينطلق بها إلى المجتمع المصرى الأكبر ليُنقذها.
من ذلك أنه واصل ما كان سلفه قد بدأه من حصار للتطرف والمتطرفين، بين الأساتذة والطلبة، ثم طوّر ذلك الحصار، داخل الجامعة، إلى هجوم سِلمى، أساسه الحوار النشط فى كل ما يهم الطلبة وهيئة التدريس، ومؤسسات المجتمع الأخرى خارج أسوار الجامعة. وضمن تِلك الاستراتيجية الشاملة، حاول تنمية موارد الجامعة، بحيث لا تستمر عبئاً على ميزانية الدولة المُرهقة بأولويات اجتماعية وأمنية أخرى. وطالب كبار مَن تخرجوا فى الجامعة وحققوا نجاحات مشهودة، بأن يتبرعوا بما يمكن أن تجود به أرواحهم للجامعة الأم، التى قضوا فيها سنوات شبابهم، ونالوا من علمها. واستجاب أولئك الخريجون، بشكل مُذهل، وهو ما شجعه على أن يفتح قاعة الاحتفالات الكُبرى، واستضافهم كمحاورين مع طلبة الجامعة، ثم كمبدعين، لإمتاع الطلبة والأساتذة بإبداعاتهم. وصدحت الموسيقى، وأصوات المطربين والمطربات فى مسرح الجامعة الكبير.
لقد قفز عثمان الخُشت بجامعة القاهرة قفزات عملاقة إلى الأمام مصرياً، وإقليمياً، ودولياً. وجعل منها نموذجا يُحتذى لبقية جامعاتنا. فجزاه الله خير الجزاء.
وعلى الله قصد السبيل