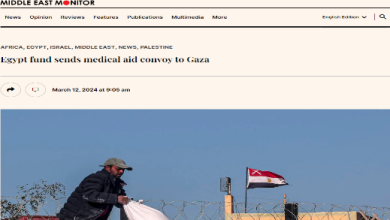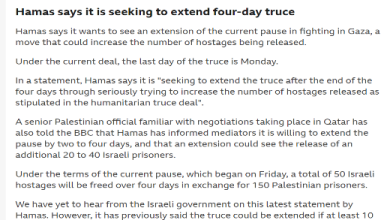عنوان هذا المقال ليس مصدره الكاتب، وإنما هو عنوان آخر مجلدات دورية «الشؤون الخارجية» التى يصدرها مجلس الشؤون الخارجية الأمريكى الذى هو ليس تجمعا لجماعة من الدبلوماسيين وخبراء السياسة الخارجية يتبادلون فيه الرأى بعد التقاعد، وإنما هو أكثر من ذلك واحد من أهم مراكز التفكير والدراسات والبحوث التى تناقش وتعمق وتنظر للقضايا العالمية والكونية ومكان الولايات المتحدة فيها. المجلد يضم مجموعة من المقالات والدراسات التى جرى نشرها من قبل مثل: «التحول الكبير: هل انحرفت الديمقراطية الأمريكية عن طريق النجاح»، «عصر الأمان المفقود: هل يمكن للديمقراطية أن تنقذ نفسها»، «نهاية القرن الديمقراطى: الصعود الكونى للأتوقراطية»، «ثورة شرق أوروبا غير الليبرالية: الطريق الطويل إلى التراجع الديمقراطى».
لماذا تأخرنا…؟!
خارج المجلد سوف نجد بداية مبكرة لمناقشة الأمر فى كتاب فريد زكريا عام ٢٠٠٣ «مستقبل الحرية: الديمقراطية غير الليبرالية فى الداخل والخارج»؛ ومقال شادى حميد «ما بعد الليبرالية فى الشرق والغرب: الإسلاموية والدولة الليبرالية». هناك ما هو أكثر من ذلك، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها فى أوروبا والدول الغربية عامة، ولكن المساحة لا تسمح، وكل ما نشر يتراوح ما بين النعى المباشر للفكرة الديمقراطية الليبرالية؛ أو مناقشة ما تتعرض له الفكرة من مخاطر، أو أحيانا عرض للصعود المثير للأتوقراطية أو الديكتاتورية أو السلطوية فى دول العالم المختلفة. ولعل أكثر النماذج عرضا فى هذه الحالة نموذج نظام بوتين فى روسيا، وشى جينج بينج فى الصين.
الليلة لا تشبه البارحة على وجه الإطلاق، ولو عدنا إلى تسعينيات القرن الماضى فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتى، لوجدنا عكس ما ذكر من عناوين، وكلها إما أنها سوف تتحدث عن «نهاية التاريخ» الذى رصد أن البشرية قد وصلت إلى منتهاها بعد انتصار النظام الليبرالى الديمقراطى الرأسمالى، ولم يعد بعد ذلك ما يقال. كانت قوى العولمة وحرية التجارة والثورة التكنولوجية العظمى التى خلقت تواصلا عالميا غير مسبوق فى تاريخ البشرية جعل من الفكرة الديمقراطية تنتقل من بلد إلى آخر حتى أصبحت «الموجة الديمقراطية الثالثة» حاملة لأغلبية دول العالم، بعد أن دخلت فى كنفها كل دول أوروبا الشرقية، والشيوعية سابقا، ودول أمريكا اللاتينية التى حكمها العسكر سابقا أيضا، وكذلك نظم الديكتاتوريات المختلفة فى تايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وأمثالهم فى القارة الآسيوية. انتشرت الديمقراطية والليبرالية فى العالم كما تنتشر النار فى الهشيم، ومعها الحديث عن حقوق الإنسان، وحرية السوق، وحقوق المرأة والأقليات، ومثل ذلك أمور.
ما الذى جعل الحال ينقلب بهذه الطريقة حتى يذهب المؤلفون والباحثون والكتاب هذه الوجهة التى تنهار فيها الديمقراطية والليبرالية إلى هذا الحد؟ لا يوجد سبب واحد، وفى كل الأحوال فإن الجديد كثيرا ما ينمو فى رحم القديم؛ والحقيقة أن هذا التحول لم يجر فجأة، وربما كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ هى أول من وضع خطا فاصلا بين عقد التسعينيات من القرن الماضى وما بدأت به الألفية الثالثة بعد الميلاد. أحداث سبتمبر كما وصفت أظهرت أن العولمة ليست فقط فى التجارة والاستثمار وحركة البشر، وإنما فى الإرهاب أيضا. السوق العالمية، والعالم الذى هو قرية صغيرة، ظهر فجأة مرعبا ودمويا وغير آمن بالمرة، خاصة أن الحرب امتدت إلى أفغانستان والعراق ثم الشرق الأوسط كله والعالم من بعده. كان صراع الحضارات الذى جاء به صمويل هنتنجتون يفسر ما يجرى، ولكنه لم يعط النصيحة أن الديمقراطية هى العلاج لمقاومة الإرهاب الذى بات راقدا تحت جلد المجتمعات، ومسافرا بين المطارات، ومهددا لما كان مكانا وموطنا للحب والسرور. الطريف أنه بعد أن بدا «الربيع العربى» مؤشرا على الزحف الديمقراطى حتى لبلاد كانت مستثناة من الصحوة الديمقراطية العالمية، فإنها كانت الغطاء الذى تمددت تحته منظمات إرهابية قاسية دفعت موجات الهجرة والإرهاب إلى مجتمعات أخرى. ظهر اليمين بعلامات فاشية فى بلد بعد آخر، ودخل الانتخابات، وفاز أو أصبح له قدرة على إفساد الحياة السياسية كلها ديمقراطية وغير ديمقراطية.
لم تكن هناك صدفة أن كثرة من هذه الكتابات التى باتت تتحدث عن مأزق الديمقراطية والليبرالية جاءت بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. فأثناء الحملة الانتخابية لم يخف الرجل نظرته الفاشية ضد مواطنيه من المسلمين، ولم يجد هناك غضاضة فى الإعلان عن نيته لطرد ١١ مليون أمريكى من أصول مكسيكية. كان للرجل موقف سلبى من المرأة والسود والملونين بكافة ألوانهم، وعندما نشر أن الرئيس الصينى حصل على موافقة حزبه لكى يستمر مدى الحياة، فإن رد فعل ترامب كان أنه ربما نستطيع فى الولايات المتحدة تجريب ذلك ذات يوم!!.. والمرجح أن ظهور ترامب كان تلخيصا لحالة ألمت بالمجتمعات الغربية فقد ظهرت فورا نسخ مختلفة منه أخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وأدت إلى فوز أحزاب يمينية متطرفة ضد المهاجرين والأقليات فى المجر وبولندا، أو حاز أنصارها على أصوات مؤيدين أكثر من أى وقت مضى. ظهر فى هذه الحالات أن رد الفعل للإرهاب والأقليات واللاجئين ليس وحده الدافع لتآكل المثال الديمقراطى، ولكن تغيرات جرت داخل الدول المختلفة، كان فيها التطرف الليبرالى والديمقراطى وراء جذب المواطن الغربى إلى الناحية الأخرى من الديمقراطية. كانت الديمقراطية والليبرالية تدريجيا مرادفا للفوضى، وإعطاء المرأة أكثر مما تستحق فى نظر اليمين، وجاء زواج المثليين لكى يعطى الديمقراطية والليبرالية مأزقا أخلاقيا أحيانا، ودينيا أحيانا أخرى.
ومن بين الأسباب التى لا يمكن استبعادها أن الولايات المتحدة، كدولة كانت دائما هى القائدة لحزمة العولمة والديمقراطية والليبرالية؛ وخلال العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين كانت واشنطن تعيش أولا أزمة اقتصادية طاحنة؛ وثانيا كان عليها أن تهزم ثلاث مرات: مرة فى أفغانستان، ومرة فى العراق، ومرة ثالثة فى الحرب ضد الإرهاب. لم تعد الولايات المتحدة قادرة لا على قيادة العالم الغربى، ولا قيادة العالم، ومع غياب القيادة الأمريكية بدا الأمر كما لو كان تغيرا فى ميزان القوى العالمى، خاصة أن روسيا والصين تحت قيادات سلطوية قاسية استطاعت ليس فقط أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أن تتخطاها. فعلت الصين ذلك عن طريق القدرة على غزو الأسواق فى العالم، وتحقيق فائض فى الميزان التجارى لصالحها مع الولايات المتحدة، والاستحواذ على أكبر احتياطى للدولار فى العالم بعد الولايات المتحدة نفسها. أما روسيا فقد فعلتها عن طريق الحركة السياسية الواسعة فى العالم، استئناف سباق التسلح، الحركة على مستوى أقاليم العالم المختلفة فى أوروبا والشرق الأوسط، مستخدمة القوة والدبلوماسية بحزم وعزم. وسواء كان الأمر واردا فى وثيقة استراتيجية الأمن القومى الروسية أو وثيقة استراتيجية الأمن الوطنى الصينية، فإن كلتيهما احتوت على أن عصر الهيمنة الأمريكية على العالم قد وصل إلى نهايته، وأن الوحدانية القطبية لأمريكا فى العالم لم يعد لها وجود.
هل وصلت الفكرة إلى منتهاها. سوف تحتاج المزيد من الفحص، والمؤكد أن النظرية تتعرض لهجمات كبيرة من داخلها ومن خارجها، ولكن ربما كان فى جانبها أنها لا تزال الفكرة الحاكمة فى الحركة الدولية، ومنها تُستمد مرجعية أخلاقية وسياسية لم ينجح أى من بدائلها فى تخطيها. الكفاءة الاقتصادية لدى «شى» لا تكفى، واليد الثقيلة والسبرانية السياسية لدى بوتين لا تخلق قطبا عظيما. كان إصرار روسيا على التدخل فى الانتخابات الأمريكية شهادة على أن الديمقراطية الأمريكية تمثل الخطر الأعظم، تلك هى المسألة!.