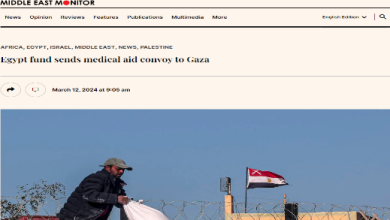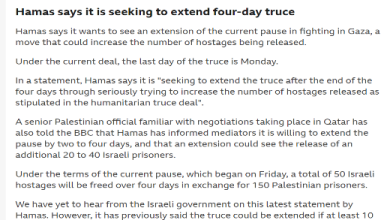نشرت صحيفة المصري اليوم مقالاً للدكتور سعد الدين ابراهيم تحت عنوان ( هل الشعب المصري في حالة عِشق دائم مع جيشه ؟ ) .. أبرز ما جاء فيه الآتي :
إن أحد معايير اكتمال الديمقراطية فى الدول الحديثة، هو خضوع المؤسسة العسكرية للسُلطة المدنية، والتعبير المُقابل لذلك بالإنجليزية Civilian Control of the Military.
ولذلك يستغرب كثير من أبناء البُلدان العربية، وبُلدان العالم الثالث عموماً، حينما يقرأون أن وزارة الدفاع فى فرنسا، أو كندا، أو السويد تتولاها امرأة، بينما مواطنو تلك البُلدان الغربية لا يستغربون ذلك الأمر بالمرة! فوزارة الدفاع، شأنها شأن أى وزارة أخرى فى تلك البُلدان- لا تزيد ولا تنقص.
بينما عِندنا فى مصر ومُعظم بُلدان العالم الثالث، تُعتبر وزارة الدفاع، شأنها شأن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وربما وزارة المالية، وزارات سيادية، أى أهم من بقية وزارات الدولة الأخرى!
وكثيراً ما نصطدم نحن المُفكرين من العالم الثالث مع المُراقبين الأجانب، بتساؤلات لا تخلوا من الاستنكار، لعدم مُقاومة نِظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى نجح الإخوان المسلمون فى الخارج فى تصويره «بأنه ديكتاتورية عسكرية»، اغتصب الحُكم فى مصر، من حكومة مدنية كان قد تم انتخابُها ديمقراطياً!
ونضطر نحن عادة مع تلك التساؤلات إلى العودة إلى المُربع الأول، حيث أساء النظام الإخوانى المُنتخب عام 2012 استخدام السُلطة، أو بمعنى أدق حين أصدر الرئيس محمد مرسى عِدة مرسومات بقوانين رئاسية، غير قابلة للطعن أو المُراجعة من أى مؤسسات دستورية أخرى، أعطى لنفسه بمُقتضاها سُلطات غير مسبوقة فى التاريخ المصرى الحديث، هذا فضلاً عن أن أتباعه ومُناصريه كانوا قد بدأوا يأخذون القانون بأيديهم، ويتحرشون أو يُعاقبون خصوم جماعة الإخوان المسلمين. هذا فضلاً عن استمرارهم فى اختراق مؤسسات الدولة، حتى بمستوياتها الوسطى. فلم يكتفوا بشغل المناصب الوزارية، ومناصب المُحافظين ووكلاء الوزارات، بل أيضاً مُديرى العموم. وربما كانت مُحاولاتهم الامتداد والنفاذ إلى مؤسسات الدولة العميقة (المُخابرات الأمنية والإعلامية) هى القشّة التى قصمت ظهر البعير.
وفى ضوء ذلك بدأت أصوات مُتزايدة تُطالب الرئيس محمد مُرسى بإجراء انتخابات عامة جديدة- إما لتجديد الثقة به وبنظامه أو لتغييره سِلمياً. ولكنه لم يستجب لتلك الدعوات المُتكررة من القوى المدنية الرئيسية، وفى ضوء عِناد الرجل واليَهم والاستعجال الإخوانى لابتلاع مصر كلها، ظهرت حركة تمرد، التى جمعت حوالى ثلاثين مليون توقيع موثق من مصريين بالغين، ذوى حقوق سياسية- انتخابية كاملة، تُطالب بانتخابات رئاسية مُبكرة. وكان هذا العدد من مؤيدى حركة تمرد، أكثر قليلاً من ضِعف العدد الذى صوّت لمحمد مرسى (14 مليون صوت).
ومع استمرار الرئيس محمد مرسى فى عِناده، ورفضه الاستجابة لأكثر من ثلاثين مليون مواطن مصرى، ومع زيادة حالات العِصيان المدنى من ناحية، والاشتباكات المُسلحة بين الإخوان وخصومهم من ناحية أخرى، اضطر الجيش للتحرك.
وحتى حينما تحرّك الجيش، فإن قيادته مُمثلة فى المجلس العسكرى الأعلى، توجّه لرئيس الجمهورية بنداءات مُتكررة، وأعطاه مُهلة أسبوع للاستجابة للمطالب الشعبية، ثم مُهلة 72 ساعة، ثم مُهلة أخيرة 24 ساعة. ومع ذلك تجاهل الرئيس محمد مُرسى هذه النداءات- الإنذارات جميعاً. ربما لأنه لم يكن صاحب القرار، ولكن مكتب إرشاده وجماعة الإخوان المسلمين كانوا هم أصحاب القرار. وربما لأنه اعتقد أن عِناده أو مُقاومته ربما تُعبئ جماهير شعبية واسعة لنُصرته، وتجعل الجيش يتراجع عن إنذاراته!
وستظل تلك الصفحة المطوية مسار تأمل وتساؤل عن ماذا دار فى مبنى المقر الرئيسى للإخوان بمرتفعات المُقطم، مما يشغل المؤرخين لسنوات طويلة مُستقبلاً!
ولكن عودة إلى موضوع هذا المقال، وهو عما إذا كان الشعب المصرى فى حالة عِشق دائم مع جيشه؟
تبدو الإجابة هى نعم. فرغم أنه كان لمصر جيوشها منذ فجر التاريخ، وتحديداً منذ الحقبة الفرعونية، قبل أربعة آلاف سنة، إلا أن الجيش المصرى، كما نعرفه الآن، لا يتجاوز عُمره مائتى سنة. فبعد سقوط المماليك (1815) بدأ محمد على باشا، مؤسّس الدولة المصرية الحديثة يعتمد على أبناء مصر من الفلاحين لبناء كل مؤسسات تلك الدولة، ومنها الجيش. وقد أذهل ذلك الجيش الوليد كل المُراقبين من الدولة العُثمانية إلى الممالك الأوروبية، خاصة بعد أن أبلى بلاءً حسناً فى كل معاركه- فى الجزيرة العربية، والسودان، وشبه جزيرة المورة- أى فى قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، حتى بات يُهدد الإمبراطورية العُثمانية ذاتها. وهو الأمر الذى دفع البُلدان الأوروبية إلى نجدة الإمبراطورية العُثمانية، رغم أنهم كانوا يُطلقون عليها (رجل أوروبا المريض)، ويستعدون لوراثته حينما يموت. وفجأة ظهر فى الأفق ذلك الوالى المصرى الطموح، الذى أوشك على إفشال مُخططاتهم. فدمّروا أسطوله فى بلاد البلقان، وحاصروه فى بلاد الشام، واجتمعوا فى لندن (1840) ليُنذروه بالعودة إلى حدوده فى مصر، مُقابل أن تصبح مصر ولاية وراثية فى أسرته. وهو ما أذعن له الرجل فى النهاية، بما فى ذلك تخفيض حجم الجيش المصرى إلى 18 ألف مُحارب.
المُهم أن جيشاً مصرياً منذ ذلك الوقت أثبت وجوده فى ميادين قتال مُتعددة، فى ثلاث قارات . وبعد ذلك فى قارة رابعة وهى القارة الأمريكية إبّان حُكم الخديو إسماعيل. ولكن نفس ذلك الجيش لم يسمح لنفسه أن يكون قوة قهر واستبداد فى يد أى من حُكامه، ولم يفتح نيرانه وأسلحته أبداً على شعبه. وبالعكس، كان ذلك الجيش منذ أحمد عُرابى، فى ثمانينيات القرن التاسع عشر، مُنحازاً للمطالب الشعبية. وقد استمر ذلك إلى اليوم، أى إلى مطلع القرن الحادى والعشرين .
وربما ذلك لأنه بعكس جيوش أخرى كثيرة تأتى قياداتها من طبقات وفئات بعينها. أما الجيش المصرى فمنذ أحمد عُرابى مروراً بعبدالناصر والسادات وحسنى مُبارك وانتهاء بالمشير طنطاوى وعبدالفتاح السيسى فهو جيش قوامه الشعب وبالشعب، ولذلك يعشقه الشعب.. والله أعلم .